رد: مكتبـــــة أدب السيــــــرة الذاتيــــــة



السيرة الذاتية العربية من طه حسين إلى محمد شكري
بيروت - مكتب «الرياض» - جهاد فاضل


في ربع القرن الماضي وُهب لكاتب مغربي اسمه محمد شكري، شهرة واسعة عربية وعالمية، فبعد أن كانت أعماله، ومن أشهرها «الخبز الحافي»، و«الشطار»، و«مجنون الورد»، تُصادر أو تُباع سراً، اعترف المجتمع المغربي والعربي بها وطُبعت طبعات كثيرة، وتُرجمت إلى عدة لغات أجنبية، ولو سئل مثقف مغربي أو عربي عن السبب الذي جعل أعمال شكري تروج كل هذا الرواج، لما أجاب سوى هذا الجواب: وهو أن الكاتب المغربي روى بصراحة ما بعدها صراحة، ما شاهده وما عاشه في حياته الشخصية من حكايات ومآسٍ وانكسارات وهزائم.
لقد اعترف، وسمّى الأشياء بأسمائها، ولم يلجأ لا إلى التقفية ولا إلى التعمية، وإنما تحدث على المكشوف عن ليل طنجة ونسائها ومومساتها، وحفر عميقاً في ذاكرته وفي الطبقة التحتية في مجتمعه، وفي أنه كثيراً ما استيقظ في الصباح عندما أتى عمال المقهى لينظفوه، فوجدوه نائماً تحت إحدى الطاولات، أو أنه وجد نفسه نائماً في العراء أمام مدخل إحدى البنايات، أو وجده وأيقظه من سباته أحد ساكني شققها..
وعلى الرغم من الحملات التي وجهها مسؤولون ومثقفون مغاربة، حريصون على الأخلاق، ضد شكري وكتبه، إلا أن شهرة شكري استمرت في التصاعد حتى فاقت شهرة مفكرين مغاربة آخرين كبار، منهم عبد الله العروي، ومحمد عابد الجابري، وبصرف النظر عن الوصف الذي يمكن أن توصف به «الخبز الحافي»، و«الشطار» و«مجنون الورد»، وهل هي روايات أم حكايات أم قصص، فلا شك أن لها صلة وثيقة بجنس أدبي سجل نجاحات مذهلة عربياً وعالمياً خلال القرن الماضي هو «السيرة الذاتية». فالسيرة الذاتية، سواء عندنا أو عند سوانا، باتت الآن الفن الأدبي الأكثر شعبية ومقروئية في العالم المعاصر قاطبة.
ولعل السيرة الذاتية هي بالإضافة إلى ذلك، الفن الأكثر بقاءً بالنسبة لكاتبها، فمن إذا سئل عن أحب كتب طه حسين إلى قلبه، وأكثرها بقاء في سيرة عميد الأدب العربي، لا يجيب أنه كتاب «الأيام»، وكتاب «الأيام» ما هو في الواقع سوى سيرة طه حسين الذاتية التي رواها في ثلاثة أجزاء منفصلة، وفي سنوات متباعدة، ثم جُمعت بعد ذلك في كتاب ضخم حمل هذا الإسم.
وقد كان كتاب السيرة الذاتية هو الأبقى في سيرة كتاب عرب كبار آخرين: فعلى الرغم من كل المعارك التي خاضها عباس محمود العقاد في حياته وفي كتبه، فإن كتابيه «أنا» و«حياة قلم»، هما أجود كتبه لا شيء إلا لأن العقاد خلا إلى نفسه فيهما، وكشف عن مكنوناتها ودواخلها، ودلّ قارءه على الكثير من خيباته وانكساراته.
ولا شك أن لتوفيق الحكيم كتب كتباً كثيرة رائعة في طليعتها «عودة الروح»، و«عصفور من الشرق»، ولكن أجودها بنظر كثيرين، كتابان هما: «زهرة العمر» و«سجن العمر» اللذان روى فيهما الحكيم سيرته الذاتية.
وهناك «حياتي» لأحمد أمين، و«غربة الراعي» لتلميذه إحسان عباس، وهو من أحدث ما كتبه أدباء عرب في هذا الفن، والكتابان آتيان في جعل النفس تتذكر وتبسط بلا تكلف أو تعمية كل ما صادفته وتعرضت له.
ويمكن وصف كتاب «سبعون» لميخائيل نعيمة بأنه أثر نفيس في هذا الفن الكتابي الصاعد، تحدث فيه نعيمة في رحلته في هذه الحياة، وهي رحلة طويلة ممتعة تابع فيها القارئ نعيمة على امتداد سبعين سنة كاملة تبدأ من سنة 1889 وتتوقف سنة 1959م.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن اكتمال «الأيام» لطه حسين بأجزائه الثلاثة قد امتد من العشرينيات إلى أواخر الستينيات، تاريخ صدور الجزء الثالث لأول مرة أمكننا أن نؤكد حقيقة أن «الأيام» رسخ جنس السيرة الذاتية بشكل مثير للانتباه، بحيث شهدت الفقرة الزمنية الفاصلة من بين الجزء الثاني والثالث من الكتاب، ظهور أهم السير الذاتية العربية الحديثة التي عاصر مؤلفوها طه حسين من أمثال سلامة موسى وأحمد أمين والعقاد وميخائيل نعيمة والحكيم، وهو أمر يدعو إلى التأكيد على الفروقات التي ميزت بين أطوار إصدار «الأيام» المختلفة.
فالجزآن: الأول خاصة، ثم الثاني، كانا مقدمة جنس السيرة الذاتية عربياً، وفتحاً جديداً في هذا اللون من الكتابة، أفلم يستفزان همم الجماهير المشغوفة بمطالعة هذين الجزءين؟ ألم يحرّكا تحريكاً قوياً قرائح الكتّاب، فاندفعوا يخلّدون أسماءهم وينشئون الكتب العديدة في هذا الفن؟
أما الجزء الثالث من «الأيام» فقد تحقق انتشاره بين الناس في زمن تمكن فيه من الاستفادة من رواج كتابة السيرة الذاتية، فجاء تتمة للجزءين السابقين عليه، وتكريساً لجنس أضحى في ذلك الوقت تمكناً، في جمهور من القراء أخذ في الاتساع، وله نماذج من الكتابات تُنسب إليه انتجتها نخبة من خيرة أدباء العصر ومفكريه.
إن جنس السيرة الذاتية العربية الحديثة، عندما ينبني على رواية مظاهر الحياة الخاصة، وعندما ينتقل منها إلى ملامسة مظاهر الحياة التاريخية العامة، بما يحيل عليه من وقائع اجتماعية، وما تفيدنا به من إحالات متنوعة على أعلام كانت لهم مساهمات فعّالة في مجالات السياسة والفكر والثقافة، يلتقي ما في ذلك شك بممارسات أدبية قديمة، عربية وأجنبية، أحكم أصحابها تصوير الصلات الكائنة بين الذات الفردية ومحيطها الاجتماعي، وهذه هي بعض العناصر المشتركة بين الكتابات الذاتية العربية القديمة والحديثة، ونتيجة لذلك، فإن السيرة الذاتية الحديثة تذكّرنا، ونحن نقرأها اليوم، بكتب السير والتراجم وبكتب الرحلات، ويخيّل إلينا أن جنس السيرة الذاتية قديم قدم الإنسان العربي، ضارب بجذوره العميقة في أرض التراث.
ولكن لا شك أن اطلاع جيل المترجمين لذواتهم العرب في مطلع القرن العشرين على التيارات الفكرية والأدبية الغربية، واحتكاك أغلبهم بنمط العيش الأوروبي والقيم التي كانت تسوده، قد فتح أعين أبناء هذا الجيل على عالم جديد خلخل تصوراتهم التقليدية، ومكّن أفكارهم من النضج وأثار في نفوسهم حواراً بناءً بين حياتهم الشرقية ومقومات العالم الجديد الذي انتقلوا إليه، فإذا هم نصفان يتنازعان في كائن واحد: نصف ينزع إلى الشرق ويحن إلى قيمه ومثله التي تغلغلت في كيانه، ونصف منصرف إلى الانغماس في حضارة الغرب وفي بضاعته الفكرية والأدبية المغرية، لأن هذا الغرب بات أنموذج التحضر وصورة لمستقبل الإنسانية.
ونحن لو نظرنا في الواقع إلى ثقافة الإعلام العرب الذين كتبوا السيرة الذاتية لوجدنا أن هذه الثقافة عربية وغربية في آن، فالسيرة الذاتية العربية الحديثة إن كان لها جذور في تراثنا، ولها بالفعل مثل هذه الجذور، فلا شك أن مرجعيتها الثقافية والفنية الحديثة هي مرجعية غربية.
لقد احتضن مشروع السيرة الذاتية العربي الحديث، المعضلة الفردية للكاتب كما احتضن المعضلة الاجتماعية، لقد كان يبحث في تأصيل الكيان الفردي وفي إيجاد صيغة أيديولوجية قادرة على تأصيل الكيان الاجتماعي وترميم هويته المتداعية المختلة، ومن ثم اقترن البحث عن الإنسان الأكمل بالبحث عن تأسيس المدينة الفاضلة التي هي في الوقت ذاته العلامة المؤشرة على هذا الكمال، والعالم الذي لا تحقق لأبعاد الإنسان الكامل إلا فيه.



السيرة الذاتية العربية من طه حسين إلى محمد شكري
بيروت - مكتب «الرياض» - جهاد فاضل


في ربع القرن الماضي وُهب لكاتب مغربي اسمه محمد شكري، شهرة واسعة عربية وعالمية، فبعد أن كانت أعماله، ومن أشهرها «الخبز الحافي»، و«الشطار»، و«مجنون الورد»، تُصادر أو تُباع سراً، اعترف المجتمع المغربي والعربي بها وطُبعت طبعات كثيرة، وتُرجمت إلى عدة لغات أجنبية، ولو سئل مثقف مغربي أو عربي عن السبب الذي جعل أعمال شكري تروج كل هذا الرواج، لما أجاب سوى هذا الجواب: وهو أن الكاتب المغربي روى بصراحة ما بعدها صراحة، ما شاهده وما عاشه في حياته الشخصية من حكايات ومآسٍ وانكسارات وهزائم.
لقد اعترف، وسمّى الأشياء بأسمائها، ولم يلجأ لا إلى التقفية ولا إلى التعمية، وإنما تحدث على المكشوف عن ليل طنجة ونسائها ومومساتها، وحفر عميقاً في ذاكرته وفي الطبقة التحتية في مجتمعه، وفي أنه كثيراً ما استيقظ في الصباح عندما أتى عمال المقهى لينظفوه، فوجدوه نائماً تحت إحدى الطاولات، أو أنه وجد نفسه نائماً في العراء أمام مدخل إحدى البنايات، أو وجده وأيقظه من سباته أحد ساكني شققها..
وعلى الرغم من الحملات التي وجهها مسؤولون ومثقفون مغاربة، حريصون على الأخلاق، ضد شكري وكتبه، إلا أن شهرة شكري استمرت في التصاعد حتى فاقت شهرة مفكرين مغاربة آخرين كبار، منهم عبد الله العروي، ومحمد عابد الجابري، وبصرف النظر عن الوصف الذي يمكن أن توصف به «الخبز الحافي»، و«الشطار» و«مجنون الورد»، وهل هي روايات أم حكايات أم قصص، فلا شك أن لها صلة وثيقة بجنس أدبي سجل نجاحات مذهلة عربياً وعالمياً خلال القرن الماضي هو «السيرة الذاتية». فالسيرة الذاتية، سواء عندنا أو عند سوانا، باتت الآن الفن الأدبي الأكثر شعبية ومقروئية في العالم المعاصر قاطبة.
ولعل السيرة الذاتية هي بالإضافة إلى ذلك، الفن الأكثر بقاءً بالنسبة لكاتبها، فمن إذا سئل عن أحب كتب طه حسين إلى قلبه، وأكثرها بقاء في سيرة عميد الأدب العربي، لا يجيب أنه كتاب «الأيام»، وكتاب «الأيام» ما هو في الواقع سوى سيرة طه حسين الذاتية التي رواها في ثلاثة أجزاء منفصلة، وفي سنوات متباعدة، ثم جُمعت بعد ذلك في كتاب ضخم حمل هذا الإسم.
وقد كان كتاب السيرة الذاتية هو الأبقى في سيرة كتاب عرب كبار آخرين: فعلى الرغم من كل المعارك التي خاضها عباس محمود العقاد في حياته وفي كتبه، فإن كتابيه «أنا» و«حياة قلم»، هما أجود كتبه لا شيء إلا لأن العقاد خلا إلى نفسه فيهما، وكشف عن مكنوناتها ودواخلها، ودلّ قارءه على الكثير من خيباته وانكساراته.
ولا شك أن لتوفيق الحكيم كتب كتباً كثيرة رائعة في طليعتها «عودة الروح»، و«عصفور من الشرق»، ولكن أجودها بنظر كثيرين، كتابان هما: «زهرة العمر» و«سجن العمر» اللذان روى فيهما الحكيم سيرته الذاتية.
وهناك «حياتي» لأحمد أمين، و«غربة الراعي» لتلميذه إحسان عباس، وهو من أحدث ما كتبه أدباء عرب في هذا الفن، والكتابان آتيان في جعل النفس تتذكر وتبسط بلا تكلف أو تعمية كل ما صادفته وتعرضت له.
ويمكن وصف كتاب «سبعون» لميخائيل نعيمة بأنه أثر نفيس في هذا الفن الكتابي الصاعد، تحدث فيه نعيمة في رحلته في هذه الحياة، وهي رحلة طويلة ممتعة تابع فيها القارئ نعيمة على امتداد سبعين سنة كاملة تبدأ من سنة 1889 وتتوقف سنة 1959م.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن اكتمال «الأيام» لطه حسين بأجزائه الثلاثة قد امتد من العشرينيات إلى أواخر الستينيات، تاريخ صدور الجزء الثالث لأول مرة أمكننا أن نؤكد حقيقة أن «الأيام» رسخ جنس السيرة الذاتية بشكل مثير للانتباه، بحيث شهدت الفقرة الزمنية الفاصلة من بين الجزء الثاني والثالث من الكتاب، ظهور أهم السير الذاتية العربية الحديثة التي عاصر مؤلفوها طه حسين من أمثال سلامة موسى وأحمد أمين والعقاد وميخائيل نعيمة والحكيم، وهو أمر يدعو إلى التأكيد على الفروقات التي ميزت بين أطوار إصدار «الأيام» المختلفة.
فالجزآن: الأول خاصة، ثم الثاني، كانا مقدمة جنس السيرة الذاتية عربياً، وفتحاً جديداً في هذا اللون من الكتابة، أفلم يستفزان همم الجماهير المشغوفة بمطالعة هذين الجزءين؟ ألم يحرّكا تحريكاً قوياً قرائح الكتّاب، فاندفعوا يخلّدون أسماءهم وينشئون الكتب العديدة في هذا الفن؟
أما الجزء الثالث من «الأيام» فقد تحقق انتشاره بين الناس في زمن تمكن فيه من الاستفادة من رواج كتابة السيرة الذاتية، فجاء تتمة للجزءين السابقين عليه، وتكريساً لجنس أضحى في ذلك الوقت تمكناً، في جمهور من القراء أخذ في الاتساع، وله نماذج من الكتابات تُنسب إليه انتجتها نخبة من خيرة أدباء العصر ومفكريه.
إن جنس السيرة الذاتية العربية الحديثة، عندما ينبني على رواية مظاهر الحياة الخاصة، وعندما ينتقل منها إلى ملامسة مظاهر الحياة التاريخية العامة، بما يحيل عليه من وقائع اجتماعية، وما تفيدنا به من إحالات متنوعة على أعلام كانت لهم مساهمات فعّالة في مجالات السياسة والفكر والثقافة، يلتقي ما في ذلك شك بممارسات أدبية قديمة، عربية وأجنبية، أحكم أصحابها تصوير الصلات الكائنة بين الذات الفردية ومحيطها الاجتماعي، وهذه هي بعض العناصر المشتركة بين الكتابات الذاتية العربية القديمة والحديثة، ونتيجة لذلك، فإن السيرة الذاتية الحديثة تذكّرنا، ونحن نقرأها اليوم، بكتب السير والتراجم وبكتب الرحلات، ويخيّل إلينا أن جنس السيرة الذاتية قديم قدم الإنسان العربي، ضارب بجذوره العميقة في أرض التراث.
ولكن لا شك أن اطلاع جيل المترجمين لذواتهم العرب في مطلع القرن العشرين على التيارات الفكرية والأدبية الغربية، واحتكاك أغلبهم بنمط العيش الأوروبي والقيم التي كانت تسوده، قد فتح أعين أبناء هذا الجيل على عالم جديد خلخل تصوراتهم التقليدية، ومكّن أفكارهم من النضج وأثار في نفوسهم حواراً بناءً بين حياتهم الشرقية ومقومات العالم الجديد الذي انتقلوا إليه، فإذا هم نصفان يتنازعان في كائن واحد: نصف ينزع إلى الشرق ويحن إلى قيمه ومثله التي تغلغلت في كيانه، ونصف منصرف إلى الانغماس في حضارة الغرب وفي بضاعته الفكرية والأدبية المغرية، لأن هذا الغرب بات أنموذج التحضر وصورة لمستقبل الإنسانية.
ونحن لو نظرنا في الواقع إلى ثقافة الإعلام العرب الذين كتبوا السيرة الذاتية لوجدنا أن هذه الثقافة عربية وغربية في آن، فالسيرة الذاتية العربية الحديثة إن كان لها جذور في تراثنا، ولها بالفعل مثل هذه الجذور، فلا شك أن مرجعيتها الثقافية والفنية الحديثة هي مرجعية غربية.
لقد احتضن مشروع السيرة الذاتية العربي الحديث، المعضلة الفردية للكاتب كما احتضن المعضلة الاجتماعية، لقد كان يبحث في تأصيل الكيان الفردي وفي إيجاد صيغة أيديولوجية قادرة على تأصيل الكيان الاجتماعي وترميم هويته المتداعية المختلة، ومن ثم اقترن البحث عن الإنسان الأكمل بالبحث عن تأسيس المدينة الفاضلة التي هي في الوقت ذاته العلامة المؤشرة على هذا الكمال، والعالم الذي لا تحقق لأبعاد الإنسان الكامل إلا فيه.
ولا شك أن لوحة السيرة الذاتية العربية الحديثة لوحة متعددة الألوان تنبض بحياة جيل كان أبناؤه يلتقون طوراً في آلامهم وأشواقهم، ويفترقون أطواراً أخرى في رؤاهم وقدراتهم علي تمثل حيواتهم وتوظيف تصوراتهم لتطوير مجتمعاتهم، ولكنهم في الحالتين كانوا يسعون جاهدين إلى تأسيس صورة جديدة للإنسان العربي الفاعل في تاريخه، الساعي إلى ترميم حلقات هذا التاريخ المفقودة، فكان عطاؤهم الفكري والأدبي بلا حدّ، وسواء نجحوا أو فشلوا نسبياً في مسعاهم، فيكفيهم فخراً أنهم كانوا منارات أضاءت بأنوارها عصرهم في زمن عصيب اختلطت فيه الطرق، وليس فن السيرة الذاتية الذي أنشأوه إلا دليلاً على أن الأدب العربي الحديث يدين لهم بانبعاثه وتجدده، لذلك لم تنته حياة هؤلاء المترجمين لذواتهم بكتابتهم لسيرهم الذاتية أو بموتهم، بل لعلها بدأت.
المصدر
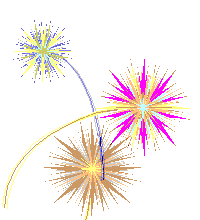

د. عبد الفتاح أفكوح - أبو شامة المغربي
aghanime@hotmail.com
المصدر
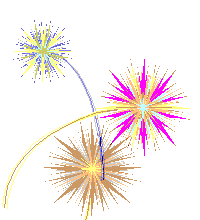

د. عبد الفتاح أفكوح - أبو شامة المغربي
aghanime@hotmail.com




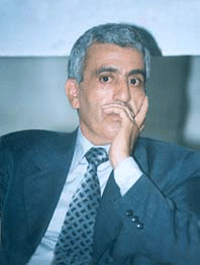






تعليق