رد: مكتبـــــة أدب السيــــــرة الذاتيــــــة


"السردية السيرية"
نبيل سليمان
إذا كانت (السيرة) في الغرب تتجذر في التراث اليوناني والروماني من الوصايا والرسائل والتاريخ ... فانطلاقتها تتعلق بالقرن السادس عشر، حيث تتوالي علاماتها الكبري، ومنها الاعترافات بخاصة، من اعترافات القديس أوغسطين إلي اعترافات تولستوي إلي اعترافات روسو ... وقد كانت السيرة الذاتية ــ أو الترجمة الذاتية كما يؤثر كثيرون ــ مثل المذكرات والرحلات واليوميات والاعترافات، ذلك الينبوع الثر للرواية الغربية.
مقابل ذلك، ثمة في نقدنا الأدبي ما يشطب السيرة من تراثنا السردي، تعويلاً علي ظهور هذا الفن كتعبير عن صعود البورجوازية الأوروبية، بعد فنّ المذكرات الذي ظهر كتعبير عن النظام الإقطاعي السابق، لكأن القرون الأموية أو العباسية أو الأندلسية أو العثمانية أو.. لم تشهد حراكاً طبقياً، ولم تعرف فتنة الأنا التي جاءت (السيرة) تعبيراً عن أسطورتها الفاتنة في الحضارة الغربية، كما عبّر أحدهم.
لكن للسيرة في التراث السردي العربي الإسلامي مدونة كبري، تبدأ بسيرة الرسول صلي الله عليه وسلم، وتتوالي ــ علي سبيل المثال ــ في سيرة معاوية وبني أمية لعوانة الكلبي (ت 147 هـ) وسيرة ابن اسحاق (ت 151 هـ) وسيرة أحمد بن طولون لابن الداية (ت 334 هـ) وسيرة صلاح الدين الأيوبي لابن شداد (ت 622 هـ) وسواها.
وهنا ينبغي التشديد علي ذخائر السيرة الشعبية في تراثنا السردي، من سيرة سيف بن ذي يزن إلي سيرة عنترة إلي سيرة الظاهر بيبرس إلي السيرة الهلالية، وكل ذلك علي سبيل المثال.
أما اللافت هنا فهو أن السردية السيرية احتشفظت بكلمة (السيرة) في السير الشعبية، بينما غلبت عليها كلمة (الترجمة) كلما تعلقت بعلية القوم من حكام وشعراء وكتّاب، لكأن (الترجمة) اقترنت بالأدب الرسمي و(السيرة) اقترنت بالأدب الشعبي. وعلي أية حال فكلمة (الترجمة) القادمة من الآرامية، استعملت في مطلع القرن الهجري السابع بدلالتها علي الحياة الموجزة للفرد، مقابل دلالة (السيرة) علي التاريخ المسهب للفرد. ومنذ معجم ياقوت إلي عهد غير بعيد من نقدنا الأكاديمي، تفرّدت كلمة (الترجمة)، حتي في نقد الرواية، وحسبي هنا الإشارة إلي كتاب عبد المحسن طه بدر (تطور الرواية العربية الحديثة في مصر) حيث أفرد فصلاً لـ (رواية الترجمة الذاتية). ولئن عدنا إلي الوراء قليلاً فسنجد للمستشرقين الألمانيين روزنتال وبروكلمان هذا الكتاب (دراسة الترجمة الذاتية التراثية).
لكن كلمة (الترجمة) الذاتية وغير الذاتية تراجعت، وعادت كلمة (السيرة) الذاتية وغير الذاتية، ومع ما عرفته السردية الروائية وسردية المذكرات والرحلات والنقد الحداثي من نشاط خلال العقدين الماضيين، أخذ السؤال يلح علي السردية السيرية سواء كانت ذاتية أم غيرية، وفي التراث كما في الكتابة المعاصرة، علي الرغم من أن سردية الاعترافات المستقلة أو المتخلَّلة في الرواية وغيرها، ما تزال ضامرة وخجولة جراء الرقيب الذاتي والاجتماعي والسياسي والديني.
بسؤال السردية السيرية ينفتح للكتابة العربية المعاصرة، وللنقد، أفق جديد. وحين يمضي هذا السؤال بخاصة إلي الرواية العربية، ينفتح لها أفق جديد أيضاً مقابل ما بدأ يتضبب من مستقبلها، علي الرغم مما أنجزت، وعلي الرغم من حداثة العهد.
ولقد بدت بالأمس القريب أهمية الحفر الروائي في التراث السردي السيري وغير السيري ــ هل يكفي أن أذكّر برواية جمال الغيطاني (الزيني بركات)؟ ــ وهو ما بدا أيضاً في الدراما التلفزيونية وفي المسرح، لكن التكرار والاجترار وعماء التجريب في أحيان متكاثرة، كل ذلك قد عجّل بانسداد الطريق، وهو ما يتطلب ــ من بين ما يتطلب، اجتراح علاقة جديدة مع التراث السردي السيري، حيث تنادي سير الرازي وابن الهيثم والشعراني والحلاج والغزالي والمحاسني والسخاوي والسيوطي وابن الخطيب و...، وحيث ما زالت تنادي السير التي جري عليها اشتغال معاصر ما، كسيرة ابن حزم (طوق الحمامة) أو أسامة بن منقذ (الاعتبار) أو الأمير عبد الله آخر ملوك غرناطة أو ابن خلدون (التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً)...
فوق هذه الطبقات السردية جاءت منذ القرن التاسع عشر طبقات متتالية مما كتب الشدياق ومحمد كردعلي والعقاد وطه حسين وأحمد أمين ومحمود كامل المحامي وسيد عويس ومحمود المسعدي و.. ومن عهد أقرب جاءت السرديات السيرية التي كتبها عزيز السيد جاسم وفدوي طوقان وفاطمة المرنيسي وأكرم الحوراني وخالد العظم و.. حتي شاع في مصر القول إننا في (مولد السيرة)، وكل ذلك من دون الإشارة إلي ما بلغته السيرة الروائية، وإلى ما بلغته السيرة التلفزيونية (هل يكفي التمثيل ببرنامج قناة الجزيرة: شاهد علي العصر)، وقد يأخذ الامتلاء والاعتزاز من يأخذان أمام هذا التراكم، لكن سؤال السردية السيرية بتطلع إلى أفق جديد، يستثمر ما أنجز في الأمس البعيد كما في الأمس القريب، كي يواجه التحدي بتجاوز ما أنجز، وببعض ذلك سيكون للرواية والدراما التلفزيونية، وللكتابة السيرية بعامة، كما للنقد، منعطف جديد.
المصدر
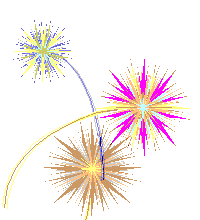

د. عبد الفتاح أفكوح - أبو شامة المغربي
aghanime@hotmail.com


"السردية السيرية"
نبيل سليمان
إذا كانت (السيرة) في الغرب تتجذر في التراث اليوناني والروماني من الوصايا والرسائل والتاريخ ... فانطلاقتها تتعلق بالقرن السادس عشر، حيث تتوالي علاماتها الكبري، ومنها الاعترافات بخاصة، من اعترافات القديس أوغسطين إلي اعترافات تولستوي إلي اعترافات روسو ... وقد كانت السيرة الذاتية ــ أو الترجمة الذاتية كما يؤثر كثيرون ــ مثل المذكرات والرحلات واليوميات والاعترافات، ذلك الينبوع الثر للرواية الغربية.
مقابل ذلك، ثمة في نقدنا الأدبي ما يشطب السيرة من تراثنا السردي، تعويلاً علي ظهور هذا الفن كتعبير عن صعود البورجوازية الأوروبية، بعد فنّ المذكرات الذي ظهر كتعبير عن النظام الإقطاعي السابق، لكأن القرون الأموية أو العباسية أو الأندلسية أو العثمانية أو.. لم تشهد حراكاً طبقياً، ولم تعرف فتنة الأنا التي جاءت (السيرة) تعبيراً عن أسطورتها الفاتنة في الحضارة الغربية، كما عبّر أحدهم.
لكن للسيرة في التراث السردي العربي الإسلامي مدونة كبري، تبدأ بسيرة الرسول صلي الله عليه وسلم، وتتوالي ــ علي سبيل المثال ــ في سيرة معاوية وبني أمية لعوانة الكلبي (ت 147 هـ) وسيرة ابن اسحاق (ت 151 هـ) وسيرة أحمد بن طولون لابن الداية (ت 334 هـ) وسيرة صلاح الدين الأيوبي لابن شداد (ت 622 هـ) وسواها.
وهنا ينبغي التشديد علي ذخائر السيرة الشعبية في تراثنا السردي، من سيرة سيف بن ذي يزن إلي سيرة عنترة إلي سيرة الظاهر بيبرس إلي السيرة الهلالية، وكل ذلك علي سبيل المثال.
أما اللافت هنا فهو أن السردية السيرية احتشفظت بكلمة (السيرة) في السير الشعبية، بينما غلبت عليها كلمة (الترجمة) كلما تعلقت بعلية القوم من حكام وشعراء وكتّاب، لكأن (الترجمة) اقترنت بالأدب الرسمي و(السيرة) اقترنت بالأدب الشعبي. وعلي أية حال فكلمة (الترجمة) القادمة من الآرامية، استعملت في مطلع القرن الهجري السابع بدلالتها علي الحياة الموجزة للفرد، مقابل دلالة (السيرة) علي التاريخ المسهب للفرد. ومنذ معجم ياقوت إلي عهد غير بعيد من نقدنا الأكاديمي، تفرّدت كلمة (الترجمة)، حتي في نقد الرواية، وحسبي هنا الإشارة إلي كتاب عبد المحسن طه بدر (تطور الرواية العربية الحديثة في مصر) حيث أفرد فصلاً لـ (رواية الترجمة الذاتية). ولئن عدنا إلي الوراء قليلاً فسنجد للمستشرقين الألمانيين روزنتال وبروكلمان هذا الكتاب (دراسة الترجمة الذاتية التراثية).
لكن كلمة (الترجمة) الذاتية وغير الذاتية تراجعت، وعادت كلمة (السيرة) الذاتية وغير الذاتية، ومع ما عرفته السردية الروائية وسردية المذكرات والرحلات والنقد الحداثي من نشاط خلال العقدين الماضيين، أخذ السؤال يلح علي السردية السيرية سواء كانت ذاتية أم غيرية، وفي التراث كما في الكتابة المعاصرة، علي الرغم من أن سردية الاعترافات المستقلة أو المتخلَّلة في الرواية وغيرها، ما تزال ضامرة وخجولة جراء الرقيب الذاتي والاجتماعي والسياسي والديني.
بسؤال السردية السيرية ينفتح للكتابة العربية المعاصرة، وللنقد، أفق جديد. وحين يمضي هذا السؤال بخاصة إلي الرواية العربية، ينفتح لها أفق جديد أيضاً مقابل ما بدأ يتضبب من مستقبلها، علي الرغم مما أنجزت، وعلي الرغم من حداثة العهد.
ولقد بدت بالأمس القريب أهمية الحفر الروائي في التراث السردي السيري وغير السيري ــ هل يكفي أن أذكّر برواية جمال الغيطاني (الزيني بركات)؟ ــ وهو ما بدا أيضاً في الدراما التلفزيونية وفي المسرح، لكن التكرار والاجترار وعماء التجريب في أحيان متكاثرة، كل ذلك قد عجّل بانسداد الطريق، وهو ما يتطلب ــ من بين ما يتطلب، اجتراح علاقة جديدة مع التراث السردي السيري، حيث تنادي سير الرازي وابن الهيثم والشعراني والحلاج والغزالي والمحاسني والسخاوي والسيوطي وابن الخطيب و...، وحيث ما زالت تنادي السير التي جري عليها اشتغال معاصر ما، كسيرة ابن حزم (طوق الحمامة) أو أسامة بن منقذ (الاعتبار) أو الأمير عبد الله آخر ملوك غرناطة أو ابن خلدون (التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً)...
فوق هذه الطبقات السردية جاءت منذ القرن التاسع عشر طبقات متتالية مما كتب الشدياق ومحمد كردعلي والعقاد وطه حسين وأحمد أمين ومحمود كامل المحامي وسيد عويس ومحمود المسعدي و.. ومن عهد أقرب جاءت السرديات السيرية التي كتبها عزيز السيد جاسم وفدوي طوقان وفاطمة المرنيسي وأكرم الحوراني وخالد العظم و.. حتي شاع في مصر القول إننا في (مولد السيرة)، وكل ذلك من دون الإشارة إلي ما بلغته السيرة الروائية، وإلى ما بلغته السيرة التلفزيونية (هل يكفي التمثيل ببرنامج قناة الجزيرة: شاهد علي العصر)، وقد يأخذ الامتلاء والاعتزاز من يأخذان أمام هذا التراكم، لكن سؤال السردية السيرية بتطلع إلى أفق جديد، يستثمر ما أنجز في الأمس البعيد كما في الأمس القريب، كي يواجه التحدي بتجاوز ما أنجز، وببعض ذلك سيكون للرواية والدراما التلفزيونية، وللكتابة السيرية بعامة، كما للنقد، منعطف جديد.
المصدر
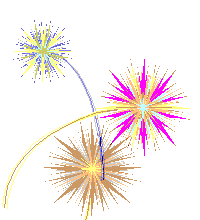

د. عبد الفتاح أفكوح - أبو شامة المغربي
aghanime@hotmail.com
















تعليق